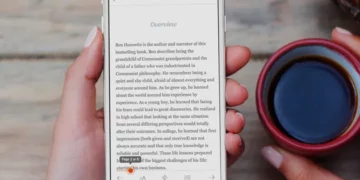بقلم د. ياسمين نايف عليان
أستاذة في علم النفس التربوي – من قلب التجربة والخبرة الأكاديمية
في غزة لم تعد السماء زرقاء ولا الليل ساكنًا. الأصوات التي كانت تبشّر بالحياة صارت تُعلن عن رحيل جديد. بين الدمار والجوع، يتشبّث الناس بما تبقّى من إنسانيتهم، وكأن الصمود لم يعد خيارًا بل علاجًا نفسيًا اضطراريًا يحفظ ما تبقّى من التوازن العقلي في زمن الإبادة. الصمود هنا لا يعني القوة بالمعنى التقليدي، بل هو عملية نفسية معقّدة تمكّن الفرد من الاستمرار رغم الألم. يستيقظ الغزّيون على أصوات الانفجارات، يبحثون عن رغيف الخبز وجرعة ماء، ومع ذلك يبتسمون، يمازحون أطفالهم، ويخترعون لحظات فرح قصيرة وسط الركام. تلك القدرة على خلق معنى للحياة في قلب الموت ليست بطولة فقط، بل آلية علاج نفسي جماعي تحفظ بقاء المجتمع من الانهيار الكامل. يستخدم الناس في غزة آليات متعددة للمواجهة: الدعاء، الدعابة، مشاركة القصص، وحتى مساعدة الجيران رغم الجوع. كل فعل بسيط، كسكب الماء لجار أو احتضان طفل، يتحول إلى ممارسة علاجية غير مباشرة تعيد للنفس شيئًا من التوازن في واقع فقد كل أشكال الأمان. في العادة، يُعد البكاء وسيلة للتنفيس وتفريغ الانفعالات، لكن في غزة أصبح البكاء رفاهية لا يملكها الجميع. فالمشاعر هنا مؤجلة إلى أجل غير مسمى، والدموع لا تجد وقتًا للنزول لأن الأولوية هي البقاء. كثيرون يعيشون حالة من التجمّد العاطفي؛ يتحدثون عن الفقد كأنهم يروون خبرًا لا يعنيهم، يضحكون في الجنائز ويصمتون أمام الكارثة. هذا ليس برودًا ولا قسوة، بل هو آلية دفاع نفسي تمنحهم القدرة على الاستمرار دون انهيار رغم الظلم والقهر. الطفل الذي يرسم بيتًا فوق الركام، والأم التي تبتسم لطفلها الجائع كي لا يخاف، والرجل الذي يوزّع الخبز رغم فقده لأسرته؛جميعهم يمارسون شكلاً من أشكال العلاج بالصمود، وإن لم يسمّوه كذلك.
الإنسان تحت الخطر المستمر لا يعيش بل ينجو. الجوع والحرمان والتعرّض اليومي للموت تُحدث إنهاكًا عصبيًا جماعيًا يجعل التفكير المنطقي ترفًا آخر. الزمن يتجمّد، الأيام تتشابه، والإدراك يختلط بين الواقع والكابوس. في هذه الحالة يُعاد تشكيل الوعي الجمعي؛ تصبح السلامة أهم من العدالة، والنجاة أعلى من الطموح. لكن رغم ذلك، يبقى في داخل كل غزّي شعاع مقاومة صغير يقول للعالم: أنا ما زلت هنا. حتى من يعملون في الدعم النفسي يعيشون معضلة مزدوجة: كيف يُسعِفون الآخرين وهم أنفسهم ينزفون؟ ومع ذلك نرى الأخصائيين في الميدان يقدمون جلسات علاج جماعي في المدارس المهدّمة أو تحت الخيام، يعلّمون الأطفال كيف يتنفسون بعمق وسط أصوات القصف، ويستخدمون القصص كأدوات لإعادة بناء الأمان الداخلي. ذلك هو الإبداع النفسي الغزّي في أبهى صوره، إبداع يولد من قلب الألم.
غزة لا تموت، لكنها تُستنزف ببطء، ومع كل وجع جديد تُنبت وعيًا جديدًا بالعالم وبالإنسان. إنها تُذكّرنا أن البقاء ليس فقط للجسد، بل أيضًا للروح التي ترفض الاستسلام. في غزة لا يُقاس الصمود بعدد البيوت المهدّمة، بل بعدد القلوب التي لا تزال تُحبّ رغم الألم. وحين يصبح البكاء رفاهية، يكون الأمل هو آخر أشكال المقاوم
ومن موقع المسؤولية النفسية والإنسانية، أقول لأهلي ولكل أهل غزة إن الإحساس بالضعف أو التعب ليس عيبًا ولا هزيمة، بل علامة على أنكم ما زلتم بشرًا رغم كل ما يُراد لكم أن تفقدوه. اسمحوا لأنفسكم بالراحة حين تستطيعون، بالكلام حين يثقل الصمت، وبالدمع حين يصبح البكاء ضرورة للتنفيس لا ضعفًا.
أما للعالم وصنّاع القرار، فالعلاج لا يكون بالتصريحات، بل بتحويل التعاطف إلى فعل، والبيانات إلى قرار. فوقف الحرب في غزة يُوضع على طاولةٍ متأرجحة بين المصالح والنفاق الإنساني، بينما يموت الأبرياء تحتها بصمتٍ لا يسمعه أحد. المطلوب ليس مزيدًا من النداءات، بل إرادة حقيقية تنهي المذبحة وتمنح هذا الشعب فرصة للشفاء قبل أن يُمحى من الخريطة ومن الذاكرة معًا. إن أول علاج لغزة هو أن يتوقف الألم، ثم يأتي بعده الدعم النفسي المنظم والمستدام. فالمجتمع المحاصر لا يُطلب منه الصمود بلا موارد، ولا يُقاس تعافيه بعدد المساعدات، بل بقدر ما يُعاد له من كرامة وحرية وأمل. فالشعب الذي صمد في وجه الموت لا يحتاج شفقة، بل يحتاج اعترافًا بإنسانيته، وشركاء يؤمنون أن إعادة بناء الإنسان تسبق إعادة بناء الحجر.